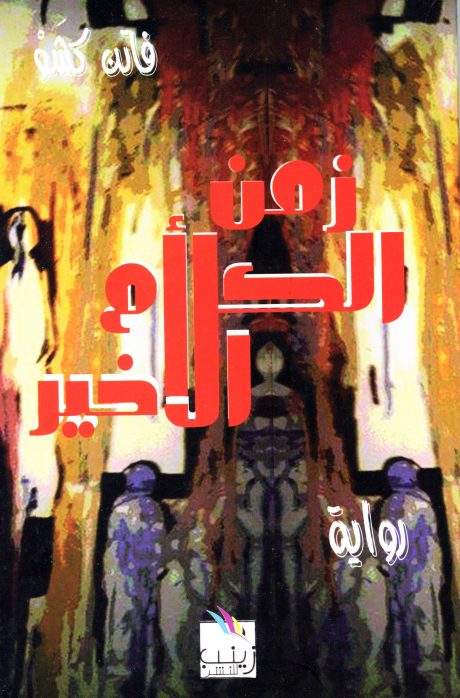الكاتبة فاتن كشو في روايتها ” زمن الكلام الأخير”، تفكك عادات مجتمعاتنا القبلية وعلاقاتها المعقدة وتحملنا في سفر على إيقاع كلماتها إلى المستقبل فنغوص قرنا ونصف في عبابه
لقد شكل الأدب بصورة عامة القاطرة التي حملت البشرية دائما نحو المستقبل، ونحو ما سيكون يوما كيفية وأنماطا. فعندما كتب جول ڤرن (Jules Verne) رواياته التي تحدثت عن اختراعات علمية كانت محض خيال في أيامه، أحب كثيرون رواياته وتهافتوا عليها، وانتقده آخرون. وإذا بالواقع الذي نعيشه حاليا يؤكد معظم ما سطره في رواياته، وكأن حالة من الإلهام قد خيمت على كيانه وهو يكتب ويسطر أحداث رواياته.
والأدب من حيث المتخيل، هو الذي يذهب بعيدا إلى حيث اللاممكن. فيجسد ما سيكون بمنظار يضعه الأديب على عينيه، فيرى ما لا يراه الآخرون. لتأتي السينما فتضيف عليه تقنياتها، محولة العمل الأدبي من فكري محض، إلى مرئي. وتعطيه بالتالي أبعادا، وثوبا يحمل كثيرا من الحقيقة. ورواية “زمن الكلام الأخير“، الصادرة عن دار زينب في تونس، هي من هذا النوع من الأدب الذي ذهب بعيدا من حيث تصوره لحياة الناس بعد قرن ونصف من الزمن. في عملية تخيل لما سيكون عليه حالنا في ذلك العالم، وطبيعة المخترعات العلمية، في تفاصيل تأخذ طابع الحقيقة وكأنها تحدث فعلا.
لكن قبل أن تدخلنا الكاتبة فاتن كشو عوالم روايتها، تطرح إحدى أهم إشكاليات الكتابة عموما وهي: عمن يبحث القارئ في الرواية التي يقلب صفحاتها بين يديه…؟ هل هو الواقع ليغوص فيه مع شخصيات الرواية…؟ أم عالم من الخيال يبعده عن واقعه…؟ ثم تتركنا لنسافر عبر أحداث الرواية قرنا ونصف قرن في المستقبل. ولكن ليس على طريقة أفلام رجال الفضاء الأمريكيين الخيالية من ألفها إلى يائها. إذ تترك لنا الكاتبة في روايتها مساحة من الواقع المعاش، فتتداخل الأحداث ببعضها، وتقترب من واقعنا، ونقترب بالتالي من أحداث الرواية في عملية تداخل فكري وموضوعي.
 عالم خاص ابتدعته الكاتبة، ربما كنا على دربه والوصول إليه. عالم يستقل الناس فيه بدل السيارات ــ التي تتحول للسياحة، والفسح الهادئة، كعربات الخيل حاليا ــ طائرات شخصية، ذاتية القيادة. تتعرف على أصحابها بموجات ممغنطة، يطلقلها الجسم. وتحلق في ممرات جوية محددة، بموجب منظومة الأقمار الصناعية. والمراقب لحركة العلم والتكنولوجيا، يحس بأننا غير بعيدين عن هذا العالم، لأن من ينظر إلى أي سلعة الكترونية بين يديه حاليا، كالهواتف الذكية، وأجهزة الكومبيوتر الخ… وكيف كانت حلما في يوم من الأيام عندما ظهرت في الأفلام السينمائية، لندرك سريعا أن ذلك قادم لا محالة.
عالم خاص ابتدعته الكاتبة، ربما كنا على دربه والوصول إليه. عالم يستقل الناس فيه بدل السيارات ــ التي تتحول للسياحة، والفسح الهادئة، كعربات الخيل حاليا ــ طائرات شخصية، ذاتية القيادة. تتعرف على أصحابها بموجات ممغنطة، يطلقلها الجسم. وتحلق في ممرات جوية محددة، بموجب منظومة الأقمار الصناعية. والمراقب لحركة العلم والتكنولوجيا، يحس بأننا غير بعيدين عن هذا العالم، لأن من ينظر إلى أي سلعة الكترونية بين يديه حاليا، كالهواتف الذكية، وأجهزة الكومبيوتر الخ… وكيف كانت حلما في يوم من الأيام عندما ظهرت في الأفلام السينمائية، لندرك سريعا أن ذلك قادم لا محالة.
تتنقل الكاتبة في روايتها ما بين عالمين؛ عالم يبعد عنا قرنا ونضف، وعالم نعيشه الآن، يتصلان ببعضهما بخيط متين، وأحداث متلاحقة. وشخصيات لكل منها حكايته وقصته مع المجتمع، ومع ذاته، في قفزات من مشهد إلى آخر. وكأننا نشاهد فيلمين، أو نقرأ روايتين في آن معا. أو كمن يعزف لحنين مختلفين على آلة موسيقة واحدة في في نفس الوقت. ليبقى الإنسان في المسلكين هو الإنسان بمشاعره وعواطفه، وقاموس تعابيره الإنسانية، التي وكما تقرر الكاتبة في روايتها، ستبقى دون تغيير أو تبديل. بالإضافة إلى البحر رفيق الأحبة وكل الحالمين، والذي لا يغيب عن صفحة من الصفحات إلا ليعود ويظهر من جديد بعبارات وتوصيفات أخرى. البحر مستودع الأسرار والذكريات، والصديق الوفي الذي يستأمنه الناس على نظراتهم، فلا هو يضجر منهم، ولا هم يملون منه…!
روايتان، كل واحدة تذهب في اتجاه. توصلنا الأولى إلى لقاء مع التاريخ من خلال حبيب قادم من بلد صنع التاريخ يوما، وشكل حلما كأحلام ألف ليلة وليلة. قادم من بغداد المنصور، والرشيد، والمأمون. ليكون احتلال بغداد من قبل الأمريكان المحطة الأخيرة في هذا القسم من الرواية، مع بعض التفاصيل عن ملجأ العامرية الذي قصفوه بقنابل مخصبة، فقتل فيه قرابة أربع مائة طفل بريء. ومن ثم تم اغتيال العلماء العراقيين على أيدي الصهاينة، والأمريكان، وملاحقتهم في كل مكان من العالم.
بينما تحملنا الثانية في جولات نعبر فيها بعض مدن تونس، بكل تفاصيل أبنيتها، وشوارعها، وأحيائها، ومعالمها، وخصائصها المعمارية والإنسانية. فنتابع حروف الكاتبة، فنصل إلى مدينة المهدية التي تركها الفاطميون كمدينة متكاملة، شاهدة على عصرهم، وعلى عجزنا في مجاراة تلك الحضارة. إلى أن نصل إلى ثورة الياسمين، حيث تصف لنا الكاتبة حال البلد قبلها، وإرهاصات الثورة، وكأنها كانت حتما مقضيا كرد على الظلم الذي وصل لذروته.
وبالرغم من كل التقدم التكنولوجي والعلمي والثقافي الذي هو عنوان المستقبل، إلا أن العقل البشري يبقى هو هو، دون تغير، أو تبدل. معششا في ثناياه؛ الإيمان بالتابعة، والتشاؤم، والتفاؤل، والخوف من نظرات الآخرين وحسدهم، واللجوء إلى العرافين وقبور الأولياء، وما إلى هنالك من أمور ترتبط بالماورائيات، والخرافات. إنه الكائن البشري بكل الأثواب التي يُلبسها لنفسيته وشخصيته وروحه، فيستعصي فهمه، ومعرفة كنهه، وردات فعله، ونمطيات تفكيره.
تتطرق الكاتبة لمشاكل المجتمع المعقدة من خلال قصة حب في أساسها مباحة، ولكن ليس من وجهة نظر القبيلة. فتناقش المفهوم القبلي الذي يبدو أكثر وضوحا وحدة في عملية الزواج. حيث يكون الزواج من الأقارب، والقريبات، وأيضا من أبناء القبيلة. أو من أبناء المدينة والجهة لو تم التوسع في ذلك. فتردد الكاتبة تلك القاعدة التي تعتبر من الثوابت في مجتمعاتنا “… الرجل له كل الحرية في اختيار شريكته أما المرأة فإنها محكومة دوما بالأعراف والتقاليد“. فتُطبق قواعد القبيلة وعاداتها على الأنثى لكونها الحلقة الأضعف في المجتمعات الذكورية، ولأن في خضوعها للقواعد حفاظ على القبيلة ونسلها…!
وتطرق باب مآسي المجتمع أيضا من خلال معاناة امرأة يتركها زوجها المهاجر إلى أوروبة بحثا عن حلمه، ويدفنها مع ولدين دون أي معيل لهم في الحياة. فتتزوج برجل يغريها برجولته، ومواقفه. ثم يترك لها الآخر ولدا جديدا. فتواجه المجتمع بفقرها، وبثلاثة أولاد تريد أن تربيهم، وتعلمهم. فلا يعطيها المجتمع سوى الجلد بألسنة لا ترحم، ونظرات سخرية، وامتهان، وتغوُّل رجاله وطمعهم بها وبلحمها، كونها تعيش في المجتمع مع أولادها بلا زوج ورجل يحميها. أمٌ عليها أن تواجه المجتمع بسبب ولد لم يتم تسجيله في السجلات الحكومية، لأن الأب كان مخادعا غشاشا في كل شيء. فتضطر أن تقدم عِرْضِها على طبق من فضة إلى أحد القضاة لكي يقوم بفرض الأمر الواقع على الزوج المزيف، ويأمره بالاعتراف بولده. إنه نظام المحاكم في بلادنا، بل نظام الموظف الكبير القوي الذي يحاول أن يستفيد من منصبه وسلطته للوصول إلى إرضاء شهواته.
ويأتي الشعر في هذا العمل السردي كاستراحة مسافر في وسط الطريق، وكعنصر خارجي، متناسقا مع حبكة السرد، ومكملا له. بل يُعطي السرد بُعدا آخر، وينقل القارئ إلى عوالم أرادت الكاتبة أن يذهب القارئ إليها. فالنصوص الشعرية التي تتداخل مع السرد، هي من نظم الكاتبة حيث إن لها مع الشعر تجربة وأصدرت ديوانا تحت عنوان ” منذ عدت من وهمي”.
ويأخذ الفساد الإداري والأخلاقي الذي ساد عالم الموظفين الإداريين في مرحلة الرئيس بن على حيزا مهما في هذا العمل السردي. وكذلك شيوع الاعتقالات التعسفية لرجال الفكر والتعليم، وللمناضلين المنضوين في الجسم النقابي العمالي والوظيفي، ولكل من عارضه. وكذلك سأم الشباب، وتفشي البطالة، والرشوة، ولجوء الشباب إلى الإدمان، وتسكع العاطلين عن العمل، وقيام بعضهم بالسرقة من أجل ركوب مراكب الموت (الحرقة)، وتسليم رقابهم لتجار البشر، من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى للمتوسط.
لننتقل عبر السطور وليس بطائرة الكاتبة المسيرة بالأقمار الصناعية إلى مرحلة التحضير للثورة وبدء إرهاصاتها. فتحدثنا عن بروز عالم جديد بكل ما فيه. شباب وشابات لديهم أجهزة حواسيب (كومبيوتر)، يتواصلون مع بعضهم برموزهم الخاصة التي لا يفهمها إلا هم، برسائل مشفرة داعية إلى الثورة على القمع والدكتاتورية، مستخدمين كل الوسائل الأخرى المتاحة؛ من رسومات، وكتابات على الجدران، ونظم قصائد الشعر، وإطلاق الشعارات، وتأليف الأغاني الخاصة بهم، مثل أغاني الراب التي تواكب وتشرح معاناة التوانسة، وتدعو للنهوض في وجه الظلم والطغيان:
امشوا في الشوارع
شوفوا الناس كي تعاني!
اهبطوا للأسواق
شوفوا الدنيا كي شعلت فيها النار!
* كاتب وباحث مقيم في باريس